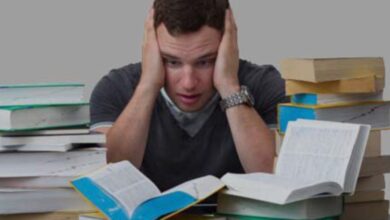ممدوح سالم يكتب: الثانوية العامة وأفسدة التعليم!

لا أحسبني إلا كملايين المصريين ملتاعًا حزنان أسفًا على ما آل إليه الحال، والحال منصوبة بلغة أهل الضاد، منكورة الشأن لا ترضي عدوًا ولا حبيبًا؛ رأسها نظام تعليمي عقيم لم يزل يأبى إلا أفسدة الأهداف والغايات الكبرى التي يأملها المصريون في أبنائهم منذ عرفوا نظام الثانوية العامة التي تقوم على قاعدة المجموع التحصيلي الأجوف الذي يفضي إلى مكتب تنسيق أعمى لا يرى عالمًا أكبر متصارعًا على أولوية تحقيق الأهداف وحاجيات المجتمع الاقتصادية والعلمية وغير ذلك؛ إنما يرى حشودًا تقف على أبواب المعاهد التعليمية المختلفة ولا تنتج إلا أنصاف متعلمين ومؤهلين على اختلافات تخصصاتهم دونما النظر إلى حاجيات المجتمع والظروف الإنسانية المختلفة.أضحت البيوت المصرية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية دور استقبال لا تغلق للدروس الخصوصية التي تستنزف مقدراتها وأقواتها.
غدت مدارسنا دورًا تنظيمية لتعاقدات أباطرة الدروس والطلاب، من بقي منهم في هذه الدور ولم تتلقفه المراكز الخاصة و(السناتر) التي أمست حاشدة للطلاب من كل فج عميق، غدا الطلاب يلهثون وراء مسميات وصفات خالية من خزائن العلم غير المشروط، فهذا إمبراطور التاريخ وذاك سيبويه النحو، وهنا سقراط الفلسفة، وهنالك زويل الكيمياء ونيوتن الفيزياء… وسلسلة لا تنتهي من هؤلاء وأولئك الذين لا يراعون في الله إلًّا ولا ذمة.
كم حاولت الدولة في هيئة تلفازها وقوافلها التعليمية أن تستعين بالخبراء والكبار وقد أفلحت إلى حين؛ إذ إن التسويق الإعلامي وبعض السماسرة قد أحبطوا التجربة. أذكر أنني تشرفت أنا وزملاء كثر بإعداد وتقديم المادة في التلفزيون المصري، وكم كانت تجربة رائعة لطلاب الثانوية قدمتها بمشاركة زميلي الأستاذ محمد الكردي في مادة اللغة العربية، كانت التجربة تقوم على الحوار بين أستاذين، نتناول فيها النص بالنقد والتحليل بمشاركة الطلاب. هذه التجربة أفاد منها الطلاب سيما الطلاب الذين يخضعون لتعلم المناهج المصرية في الخليج، وأزعم أننا أفدنا طلابنا في ربوع مصر، غير أن التسويق والدعاية الإعلانية لم تكن كما ينبغي. ولم يكن الأجر مجزيًا بحال، ولا حتى قريبًا من أجور حاملي الكاميرات في برامج إعلانية أو درامية؛ فتركت المسألة، وأكمل زميلي محتسبًا.
وكانت الطامة الكبرى هذا العام وبعض العام الفائت في تسريبات الامتحانات التي غدت وغدونا بها أضحوكة العالم من أقصاه إلى أدناه. وأبى المسئولون إلا أن نزداد غيظًا بتصريحاتهم وتبريراتهم غير المنطقية في تمرير تلك التسريبات، وظل الناس في حيرة من أمرهم: أيتبعون موقعًا مسحورًا يدعى الشاومينج يتحدى الدولة في أجهزتها السيادية حتى النخاع، أم يلجؤون إلى توقعات الأباطرة المنوه عنهم أعلاه؟ والكتاب المدرسي يشكو هجران قوم اشتروه منذ شهور، ولم يدونوا عليه مسمى لهم.
وها نحن الآن على أعتاب تنسيق عقيم أعمى، يشتت هنا وهناك، غير ذي اعتبار لقدرات أو ميول، ربه وهاديه مجموع مشكوك في صحته أو غير ذي مهمة واعتبارٍ عند أصحاب الألوف ممن لديهم المقدرة على تسكين أبنائهم في الجامعات الخاصة؛ أما الآخرون ممن لا سند لهم إلا المجموع فأولئك مع الذين اهتدوا إلى غياهب المدرجات المتهالكة، والجدران البائسة، والأعداد المحشورة إلى يوم التلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهنا نتساءل: أينانا من النظم التعليمية الناجحة على مختلف ألوانها ومناهجها مثل فنلندا وماليزيا وتجارب أخرى لا تعد ولا تحصى؟
كيف لنا أن ننسف تلك المنظومة غير المأسوف لنسفها هي والقائمين رضا بحالها على إقرارها واستدامتها؟
أتصور أن المصريين لم تعقم قرائحهم ولم تعدم ضمائرهم في الوصول إلى حلول وتخليق نماذج مشرفة وابتكارية رائعة.
نحن مثل غالبية المصريين لا نملك إلا الصبر والتصبر والاحتساب حتى يأذن الله بأن نكون على بصيرة من أمرنا. لكن هذا الإذن مرهون بصحة عزيمتنا في أننا نستطيع. فهل نستطيع؟
هذا عن التعليم ما قبل الجامعي، أما عن التعليم الجامعي ونظمه فذلك له حديث لا ينتهي، وأظنه لن!
ممدوح سالم
نقلاً عن ساسة بوست