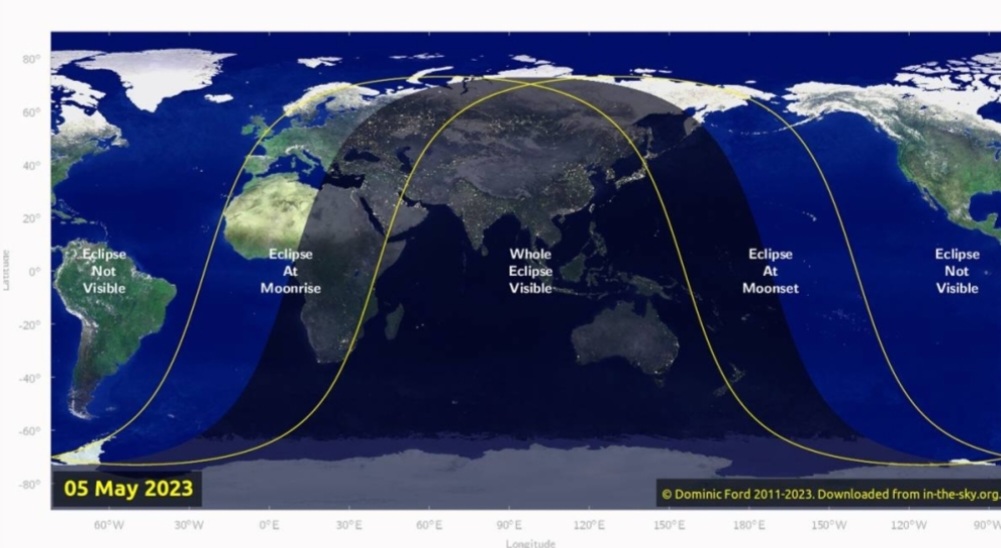فهم الذات أساس لتربية الأطفال

 محاولة فهم أنفسنا تفتح الباب على مصراعيه لفهم الآخرين لنا، فإذا أدرك الوالدان احتياجات أولادهم النفسية فسيتمكنان من الفصل بين ما يريدونه هم وما يرغبونه وبين ما يجب أن يروا أولادهم عليه، فرؤيتنا للحياة ليست بالضرورة نفس رؤية الآخرين لها «فالقاعدة الغالبة أن الناس لا يدركون الحياة كما هي فعليًا، ولكنهم ينظرون للعالم كما يريدون وكما يعتقدون».
محاولة فهم أنفسنا تفتح الباب على مصراعيه لفهم الآخرين لنا، فإذا أدرك الوالدان احتياجات أولادهم النفسية فسيتمكنان من الفصل بين ما يريدونه هم وما يرغبونه وبين ما يجب أن يروا أولادهم عليه، فرؤيتنا للحياة ليست بالضرورة نفس رؤية الآخرين لها «فالقاعدة الغالبة أن الناس لا يدركون الحياة كما هي فعليًا، ولكنهم ينظرون للعالم كما يريدون وكما يعتقدون».
فإدراكنا لحاجات أولادنا يجعلنا نفكر بنوع من المنطقية بعيدًا تمامًا عن التعصب أو الحكم الذاتي، مما يتيح للأسرة أن تعيش في حالة معتدلة من الصحة النفسية، فلكي تكون على وفاق مع شخص ما، عليك بفهمه والقرب من قلبه وعقله ومحاولة استيضاح مكنوناته، فسوء الفهم هو الغالب على العلاقات الإنسانية نتيجة للبعد عن محاولة استيضاح دواخل الإنسان.
محاولة ارتقاء الوالدين على حالة القلق الدائمة أثناء تربية أولادهما سوف تثمر بصورة إيجابية على الأسرة جميعها، وكذلك محاولة نسيان الأحكام المسبقة أيضًا سيكون لها عظيم الأثر في أسلوب تعامل أولادنا معنا، فعند إعطاء حكم مسبق على الأبناء وتصديقه تمامًا وباقتناع، بل وجعله غير قابل للنقاش، لأننا أولياء الأمور أكثر حكمة وأكثر علمًا من وجهة نظر أنفسنا، يجعلنا نتجه نحو تفسير كافة سلوكيات أبنائنا بما يتناسب مع حكمنا المسبق فقط، ونبررها على أنها تعزيز له. فلو رأى الوالد أن ابنه ناكر للجميل مثلًا سيبرر كافة تصرفاته على أساس هذه الفكرة ومن هنا فهو يجهضه حقه تمامًا، ولا يدرك أبدًا أن إطلاق تلك الأحكام المُسبقة يجعل أولادنا في حالة من المُقاومة النفسية وينظرون إلينا على أننا اضطهاديون وديكتاتوريون ويتعاملون معنا بمزيد من المقاومة والتصادم مما يخلق هوة واسعة بين الطرفين.
«فقد قال السلف لاعب ابنك سبعًا، وأدبه سبعًا، وآخه سبعًا، ثم ألق حبله على غاربه»، كما بين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ».
في مرحلة ما تعلمت أن السلوك يصدر نتيجة للمشاعر، والمشاعر نتيجة للأفكار، والأفكار تنبع من مصدرين هما التربية والتعليم، أي اللبنة الأولى التي يغذي بها الآباء أولادهم، ولكي يعملوا على تغيير سلوك ما في أبنائهم بمواجهة هذا السلوك بشراسة لهو من الأخطاء الفادحة التي لا ينتبه لها الآباء، فلكي تغير سلوكًا ما عليك أولًا بالعمل على تغيير القناعات والاهتمامات التي مر بها الإنسان أثناء تربيته، ولن تصل لذلك عن طريق دور القاضي والموجه، ولكن عن طريق دور الصديق الذي يتقصى الأسباب الفعلية والحاجات الرئيسية النابع عنها هذا السلوك، ففي أغلب المواقف المشحونة داخل الأسرة تجد الجملة السائدة «أرجوكم افهموني، أو لماذا لا تفهمون ما أريده»، ألم يسمع كل منكم تلك الجملة مرارًا وتكرارًا، لماذا لا ننتبه لهذا الأمر مع أولادنا وندرك رغبتهم، لا في أن ننظر للأمور بصورة سطحية فارضين عليهم منهجيتنا نحن في الحياة، ولكن أن نحاول العبور لداخل عقولهم وقلوبهم لندرك ما يحتاجونه فعليًا ونحاول التواؤم مع تلك الأمور، علينا أن نكون كالمحيط الذي يحميهم من الخارج وليس الذي يخنقهم، من يراقب ويرشد دون ضغط أو ضغينة ليس من يقيد ويتحكم ويتهكم، فالأبناء أفراد وكل فرد يعيش في عالم خاص به، وقد لا تمثل اهتماماتنا شيئًا لهم، علينا إدراك تلك القاعدة ومحاولة معرفة ما هي الأشياء الهامة للفرد لا ما نريد توصيله نحن إليه وقد يقابله بنوع من الفتور.
إذا استطاع الوالدان أن يدركا تلك القاعدة فسيتمكنان من عبور نفسية أولادهم وربما يتمكنان من توريد الأصول التربوية الصحيحة لهم ولكن عبر إطار جديد يتماشى مع أسلوب استقبالهم لتلك المعلومات، قد أرى ابني لا يصلي وأريد إرشاده إلى الصلاة، فماذا عليّ أن أفعل؟!
أن أذهب لاجتذابه من يديه معنفًا إياه لماذا لا تصلي وأسبه وأورد إليه من الألفاظ السيئة بما يجود به لساني؟! مما يخلق لديه نفورًا من الصلاة، أم أطلب منه أن يذهب ليتوضأ ويحسن وضوءه وقد أذهب معه أعلمه وأرشده بألفة ومحبة مع ذكر أن الوضوء يجعله ممن تنطبع على أساريرهم الأنوار الربانية، ثم أخبره أنني أحب مثلًا أن يخرج معي للمسجد المُجاور لنؤدي الصلاة، أو أن أكون إمامًا لهم في المنزل فتشع روح السكينة في قلوب الجميع؟ وبعد الصلاة أشجعه بقبلة أو أذكر «يا الله ما محلى هيئتك وجمالك» وأجعله يشعر ببعض الكلمات اللطيفة أن الصلاة تجعله مضيء الوجه جميل المحيا، مما ينطبع داخل نفسية الطفل بصورة إيجابية ومع تكرار الأمر يصبح عادة فسمة سلوكية تصحبه طوال حياته، عوضًا عن خلق نفور ذاتي منها ونظل في دائرة فرض الفعل ومقاومته طوال الحياة، فيمتد السلوك العنادي لأمور أخرى وشتى في الحياة الأسرية ويصبح طابعًا لشخصية أطفالنا، ولكن السؤال الملح هنا هل نستطيع فعل ذلك مع أبنائنا في غياب المحبة والود المتبادل؟!
لو تحرينا الهدوء في ردود أفعالنا والتفكير مسبقًا في رد فعل من أمامنا قبل أن نفعل ما نريد، واحترمنا ذات الآخرين مهما بدوا لنا جهلاء وصغارًا في السن، وكنا حياديين تمامًا نحو ما نريده نحن والطريقة التي نفكر بها ونستقبل بها ردود أفعال الآخرين، لاستطعنا التغلب على الكثير من المشكلات الأسرية التي نعانيها الآن من تفكك وعناد ونفسيات طفولية مهدمة ومتفسخة وغير قابلة حتى للتأهيل، لأنه وباختصار الوسط المحيط نفسه يحتاج للتأهيل وليس نفسية أولادنا فقط، فلكي نربي الطفل علينا أولا تربية أنفسنا فالحياة وفرت لنا نماذج نجاح كثيرة، والإنسان لا يحتاج بالضرورة السعي نحو نموذج جديد أو خبرة ذاتية خالصة ليطبقها في حياته، بل ربما عليه الموازنة ما بين خبرته الذاتية والنماذج المتاحة لينتقي منها أفضل ما يناسب واقع حياته الحالية، وما يناسب ظروف المجتمع بمتغيراته والتي يخضع لها الأبناء ويتفاعلون معها عبر مراحل نموهم المختلفة، فالنموذج الناجح قد يقبل التعديل والتكييف وإعادة التشكيل والقولبة ليناسب نمط حياتنا الذي نريده.
فالأسرة هي الوسيلة والأداة التي تمنح الأفراد الرصيد الأول من أساليب السلوك الاجتماعية، وكأنها تمنحه الضوء الذي ينير دربه فيما بعد والبوصلة التي توجه حياته وترشده في جميع تصرفاته، فهي المدرسة التي تلقنه القيم والمعايير وتعده للتفاعل الاجتماعي وتعمل على تشكيل شخصيته منذ المهد، فنجد أن كل إنسان منا يطبق ما تربى عليه من قيم ومعايير وسلوكيات في تفاعله مع الآخرين، فأي حياة تريدون لأبنائكم وأي وجهة لهم ترسمون؟!
فهل فكرنا جميعا أن الطفل منذ المهد إلى مرحلة الشباب نحن من نضع له قوانينه الداخلية ونحن من نثبت له مفاتيح ذاته، فمنذ ولادته نلقنه أول دروسه في الصواب والخطأ، فيما يجوز ولا يجوز، في الجيد والسيء وما عليه أن يفعل وما يجب أن يتجنبه بدون نقاش أو مراجعة، هل فكرت كل أم وكل أب أن هذا الرصيد من السلوكيات يحمله الطفل معه أثناء التدرج في أدوار حياته، وهل أيقنا بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الرصيد الأول هو الرصيد الثابت ويزيد عليه ما يكتسبه الفرد من سلوكيات أثناء نموه، فالأصل هنا لا يتغير ويجتذب ما يشابهه وما يتماشى معه من سلوكيات جديدة عبر كل مراحل نموه، فعلى كل أب وأم منا أن يعلم جيدًا أن التربية والتنشئة الاجتماعية هدفها الأساسي تكوين الشخصية الإنسانية للأبناء وتنمية ذواتهم بصورة إيجابية وليس طمسها والتحايل على فرصهم في الحياة ليكونوا صورًا ممسوخة منا، فعليهم أن يعملوا على تكوين الضمير عند أولادهم بغرس القيم الإيجابية والتأكيد على مفهوم الذات الإيجابي بتلاشي أسلوب التشهير بالأبناء وبسلوكياتهم أمام الغرباء، بل والتعامل معهم بنوع من النضج والحكمة، فعقل الصغير يسجل كل كلمة وحرف وسلوك وتصرف ليعيد إنتاجه فيما بعد على مستوى تفاعلاته القادمة. الكثيرون من الآباء لا يدركون أن كل الأمور التي ترتبط بالفرحة والحزن والألم والسعادة هي أدوات مهمة في تشكيل كافة جوانب حياتنا، بإدراكهم لتلك الحقيقة سيعملون جليًا على تغيير أفعالهم لتتغير نتائجها على أطفالهم وعلى أنفسهم بما يضمن للنتائج الإيجابية أن تنعكس بمستقبل مشرق، فالحياة ليست هي من يرسم لنا طريقنا ولكن ما نحمله داخل عقولنا من معتقدات تمثل قوى مهمة للبناء والهدم كما أوردنا في الفقرات السابقة، فعلى أساس مخزوننا من تلك المعتقدات تتكون لدينا صورة نهائية وثابتة للحياة ننحو نحوها، وعليه فعلى الجميع أن يقف مع ذاته لبرهة ليتأمل ما يمتلكه داخل عقله من موروثات عبر تربيته فيعمل على تفريغها ويضعها أمام وعيه في حالة من التقييم والانتقاء والنقد، ومن ثم في تلك الحالة علينا أن نلغي تمامًا فكرة تقييم الآخر لنا إن تخلينا عن موروث معين أو أسلوب تربوي بذاته، فالآخر ليس من يدير حياتنا ولن يمضي معنا كل وقتنا ولن يهبنا السعادة، فلن يكون سوى محور للنقد فقط وليس علينا الانصياع له ولنظرته وانطباعه العام عنا، فهو ليس جلادًا يحتم علينا أن نعيره الاهتمام الكلي بما يفسد استمتاعنا بحياتنا الخاصة، وإن كان النقد البناء له دوره وهنا تكمن قوة العقل وحكمته في النظرة الكلية للأمور وانتقاء ما يناسب حياتنا.
فالأجدر بالآباء معاملة أبنائهم بعين البصيرة والحكمة، فحتى الآباء الناجحون والأسر المتوافقة لابد وأن تعتريها عثرات الحياة لتضعها في خضم التجربة، فالتعثر والتخبط لبعض الوقت ليس هو الأزمة ولكن دوام التخبط هو الأزمة بعينها، فلكي نجعل الآخرين يقتنعون بأسلوبنا في النصيحة علينا أولا علاج اندفاع مشاعرنا ودوافعنا وتغيير وجهة أحاسيسنا الداخلية، حتى يحدث تحول المشاعر بالانفتاحية نحو الآخر فيشعر بما نريد أن نوصله إليه دون عنف أو مقاومة حسية، فالعلاقة التربوية علاقة محبة واحترام في أساسها ومن يحب دون قيد أو شرط وفق طبيعة الآخر يتعلم خلال رحلة الحب تلك كيف يتوافق مع عقله ويتقبله وإن بدا له غريبًا ومختلفًا، فجميل جدًّا أن نجعل أبناءنا يشعرون بالحب في كل المواقف حتى موقف النقد بالرغم من ميلنا الشديد أن يسلكوا وفق منهجية سلوكية معينة نحن نراها أصح وأسلم.
ولكن ألم يفكر كل منا هل نحن قادرون على تصدير شعورنا بالحب نحوهم ونحن في أشد حالات عصبيتنا وثورتنا؟! هنا لن أجيب سأترك الإجابة لكم، إن استطاع كل منا أن يخلق مساحة الود تلك التي تضمن لنا التفاعل مع أولادنا في محيط العائلة بنوع من الألفة والتسامح واحترام رأي الآخر، ومنحهم مساحة من النقاش وإبداء وجهات النظر، فسنكتشف أن الرؤية المشتركة تحمي الأفراد من الاتجاه نحو المعايير الخاصة والفردية والحكم بناء على المرجعية الذاتية للشخص دون احترام وجهة نظر الآخر ولا احتياجاته ورغباته، وهذا السلوك كفيل بخلق نوع من التشوش في المحيط الأسري، فالفكرة هنا تكمن في تكوين رؤية يتقاسمها كل أفراد الأسرة.
المصدر: ساسة بوست